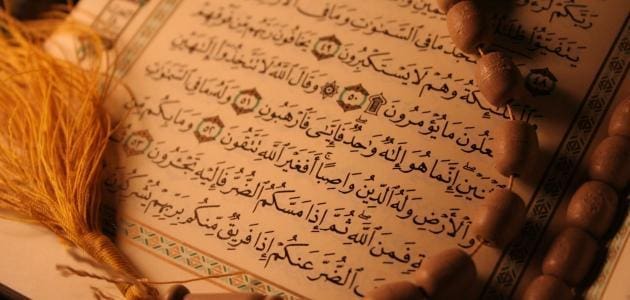أنواع المدود في التجويد يهتم الكثير بتعلُمِها من قارئي القُرآن، حيث إن علم التجويد يشمل عِدة أحكام تقودنا إلى النُطق الصحيح، فتجد بابًا خاصًا بالنون الساكنة والتنوين والميم الساكنة، وكذلك المدّ.. هو من أول الأحكام التي يجب تعلمها، لذا قام موقع زيادة بتوفير أبرز أنواعُه.
أنواع المدود في التجويد
علم التجويد أحد العلوم التي تختص بدراسة الحروف والكلمات، وكيفية نُطقها بالطريقة الصحيحة من مخارجها، ويشتمل التجويد على أحكام كثيرة خاصة بقراءة القُرآن، فمن الضروري تعلُّم قراءتهِ بطريقة صحيحة خالية من الأخطاء واللحن؛ لاستقامة المعنى.
يُعد المدّ أحد أحكام التجويد المُهمة، وهو يعني الزيادة وإطالة الصوت في حروف المدّ واللين، ويختص بحروف “الألف والواو والياء”؛ حيثُ يأتي في حرف الألف في حالة سُبق بفتحة، والياء عندما يسبقه حرف مكسور، والواو إذا سُبقت بضمة، وتختلف أنواع المدود في التجويد، لذا من الضروري تعلمّها.
اقرأ أيضًا: شرح الاسم المقصور والممدود والمنقوص
أولًا: المدّ الأصلي
هو أول أنواع المدود في التجويد، ويُعرف أيضًا بالمدّ الطبيعي، وترجع أهمية تعلُمه إلى دوره في استقامة المعنى، وليس هُناك سببًا خاصًا للنُطق به، فهو يصدر عن الإنسان تلقائيًا، وينطق به الإنسان دون زيادة أو نُقصان في الحركة.. وسُمي بذلك نظرًا لأن الإنسان يتمكن من إدراكِه ذاتيًا.
لا يتحقق النُطق الصحيح للحروف دون الإتيان بالمد الطبيعي، ويأتي في ثلاثة حروف، يتكون من حركتين.
- الألف الساكنة بعد حرف مفتوح: “قْالَ”.
- الواو الساكنة بعد حرف مضموم: “سمِيْع”.
- الياء الساكنة بعد حرف مكسور: “رسُوْل”.
ثانيًا: المد الفرعي
الفرع الثاني من أنواع المدود في التجويد هو المدّ الفرعي، وسُمي بذلك لأنه يتفرع عن المدّ الطبيعي، كما يُمكن إطلاق عليه “مد مزيد” حيث يزيد في الصوت والحركة عن المد الطبيعي، ويتم الإتيان به لبعض الأسباب؛ في حالة كان الحرف التالي لحروف المدّ حرف ساكن أو همزة، وينقسم المدّ الفرعي إلى خمسة فروع أخرى.
1- المدّ اللازم
يكون المدّ اللازم في الكلمة التي يُلحق فيها حرف المدّ حرف ساكن لازم سواء في حالة وصل الكلمات أو وقفها، لذلك سُميّ باللازم، كما يكون المدّ اللازم في حروف فواتح السور.
- مقدار المدّ اللازم: ست حركات.
- حكم المدّ اللازم: واجب.
- مثال: الألف التي يلحقها حرف ساكن “الطامْة”، الياء التي يُلحقها حرف ساكن، الواو التي يلحقها حرف ساكن.
هُناك فرعين من المدّ اللازم، وينقسم كِلاهُما إلى فروع أخرى، وهُما: مدّ لازم كلمي، ومدّ لازم حرفي، وينقسم المدّ الكلمي إلى نوعين: مثقل، ومُخفف.
- مدّ لازم كلمي مثقل: هو الذي يكون فيه حرف المدّ سابقًا لحرف ساكن مُدغم في الحرف الذي يليه في كلمة واحدة، مثل: “الضآلين”.
- مدّ لازم كلمي المخفف: هو الذي فيه حرف المدّ سابق لحرف ساكن غير مُدغم في الحرف الذي يليه في نفس الكلمة، مثل: “الآن”.
يُعد النوع الثاني من أنواع المد اللازم المدّ الحرفي، ويكون المدّ الحرفي في أحد أحرف الكلمة، وغالبًا ما يكون في بدايات السور في سبعة أحرف، مثل: “ق”، فتتكون من “قاف وألف وفاء” والمدّ يكون في نُطق حرف الألف، وينقسم المدّ الحرفي إلى قسمين: حرفي مُثقل، وحرفي مُخفف.
- مدّ لازم حرفي مُثقل: يأتي في حالة كان الحرف يتكون من ثلاثة مقاطع ويتوسط في النُطق حرف مدّ مُدغم في الحرف الذي يليه، مثل: “طسم”، فتكون تهجئته “طاء سين ميم”، فنجد أن حرف السين يضُم حرف الياء “حرف مدّ” يليه حرف النون المُدغمة في الميم.
- مدّ لازم حرفي مُخفف: يأتي إذا كان حرف المد المنطوق به في الحرف يليه حرف ساكن غير مُدغم فيما يليه، مثل: “حم” والذي يتكون من “حاء وميم”.. فتجد الياء متوسطة حرف الميم ولا يتم إدغام الميم في حرف تالي له.
اقرأ أيضًا: تدريبات على الاسم المقصور والمنقوص والممدود
2- مدّ البدل
يأتي مدّ البدل في حالة سُبق حرف المدّ بهمزة، بشرط ألا يأتي بعده حرف ساكن أو همزه، فالأصل في الكلمة همزتان، فيكون المدّ حينها بدلًا من الهمزة الثانية؛ ولهذا سُمي بالبدل، وفي حالة كان غير مُبدل عنها فيُسمى حينها بالشبيه بالبدل، وهو أحد أنواع المدود في التجويد.
- مقدار مدّ البدل: حركتان.
- حكم مدّ البدل: جائز.
- مثال: الألف المسبوقة بالهمزة “ءادم”، الياء المسبوقة بالهمزة “إيمانًا”، الواو المسبوقة بالهمزة “أوذوا”.
3- المدّ العارض للسكون
يُكون المدّ العارض للسكون في أواخر الكلمات؛ وذلك إذا كانت الكلمة آخرها حرف مُتحرك مسبوق بحروف المدّ، بشرط أن يُسكن الحرف عند الوقف، وينقسم حُكمه وعدد حركاته؛ وفقًا لنوعه.
- مدّ عارض مُطلق: أصله المدّ الطبيعي، في حالة الوصل يكون عارضًا للسكون، وحُكمه جائز في القصر أو التوسط أو الطول، أي يُمكن الإتيان به بست حركات أو أربع حركات أو حركتين، مثل: “ذي الأوتاد”.
- مدّ عارض متصل: أصله المدّ المُتصل، في حالة تطرف الهمزة بعد حرف مدّ، فيكون مُتصلًا في حالة الوصل، وعارضًا في حالة الوقف، وحكمُه وجوب المدّ أربع أو خمس حركات في حالة الوصل، وجواز المد أربع أو خمس أو ست حركات عند الوقف، مثل: “من يشاء”.
- مدّ عارض بدل: إذا كان أصل المدّ بدلًا من همزة في حالة الوصل، فيكون عارضًا للسكون في حالة الوقف، ويكون حُكمه جواز إتيان حركتين أو أربع أو ست حركات، مثل: “حُسن المآب”.
- مدّ عارض لين: في حالة كان أصل المدّ حرف ليّن فيجوز حينها أن يكون عارضًا للسكون في حالة الوقف، والإتيان بحركتين أو أربع أو ست حركات، مثل: “من خوْفٍ”.
4- المدّ المتصل
يأتي المد المُتصل عند لِحاق حرف المد بهمزة في نفس الكلمة، سواء كان في وسط الكلمة أو نهايتها، والذي يُعد واحدًا من أنواع المدود في التجويد.
- مقدار المدّ المتصل: قد يكون أربع أو خمس حركات متوسطة.
- حكم المدّ المتصل: واجب النُطق به.
- مثال: الألف المُلحقة بهمزة “السماء، القائمين”، الياء المُلحقة بهمزة “هنيئًا، تفيئ”، الواو المُلحقة بهمزة “سوء”.
5- المدّ المنفصل
يُأتي المدّ المُنفصل في حالة لِحاق حرف المدّ بهمزة في كلمتين، ويُطلق عليه الكثير من الأسماء، منها “المدّ البسط، ومدّ الكلمة بالكلمة، ومدّ حرف بحرف”، وسُمي مُنفصلًا لانفصال الهمزة عن حرف المدّ.
- مقدار المدّ المنفصل: أربع حركات أو خمسة.
- حكم المدّ المنفصل: جائز.
- مثال: الألف التي تلحقها همزة مُنفصلة “لا أضيع”، الياء التي تلحقها همزة مُنفصلة “لا ندري أشرٌ..”، الواو التي تلحقها همزة مُنفصلة “قالوا إنما”.
ينقسم المد المُنفصل إلى فرعين، وهُما: المدّ المنفصل الحقيقي، والمنفصل الحُكمي.
- المنفصل الحقيقي: هو الذي يكون ثابتًا في الخط والنطق، مثل: “متخذي أخذان”.
- المنفصل الحكمي: هو الذي يكون ثابتًا في النُطق دون الخط، مثل: “هؤلاء”.
اقرأ أيضًا: الفرق بين الألف المقصورة والألف الممدودة
ما يلحق المدود في التجويد
هُناك بعض أنواع المدود في التجويد الأخرى التي ألحقها العُلماء بالمدود، وتأخذ نفس حُكم المدود الأخرى، ولا يُمكن الاستغناء عنها في قراءة القُرآن الكريم.
1- مدّ العوض
يأتي مدّ العوض في التنوين المفتوح، فيتم إبدالُه ألفًا في حالة الوقف، ويكون الحُكم حينها وجوب المدّ بمقدار حركتين.
- مثال حرف المدّ المكتوب: “حكيمًا”.
- مثال حرف المدّ غير المكتوب: “سواءً”.
- مثال نون التوكيد المكتوبة تنوين: “وليكونًا”.
2- مدّ اللين
يأتي في حالة كان حرفي المدّ الواو والياء ساكنين، وسبقهُما حرف مفتوح، وسُمي بمدّ اللين لأنه لا يحتاج إلى الكثير من التكلُف للنُطق بالحرف، ويُمدّ في تلك الحالة حركتين أو أربع أو ست حركات في حالة الوقف، أمّا في حالة الوصل لا بُد من قصر الحرف.
- مثال: “ويْل”، السوْء”.
3- مدّ التمكين
يُعد أحد أنواع المدّ الطبيعي، ويأتي إذا التقت واو مُتحركة مع واو مدّ، أو ياء مُتحركة مع ياء مدّ، ويكون حُكمه حينها وجوب المدّ بمقدار حركتين.
- مثال ياء المدّ اللاحقة لياء مكسورة: “حُيِّيتم”.
- مثال الواو المضمومة يلحقها واو مدّ أو ياء مكسورة: “يلْوون”.
4- مدّ الصلة
ينقسم مدّ الصلة إلى نوعين: صلة صغرى، وصلة كبرى، فأمّا الصلة الكُبرى فتكون في حرف الهاء الزائد سواء كان مضموم أو مكسور، المسبوق بحرف مُتحرك ويليه همزة قطع، وحُكمه الإشباع بمقدار أربع أو خمس حركات، مثل: “فألقِهْ إليهم” ففي حالة الوصل يتم كسر الواو فتُنطق مدّ.
أمّا مدّ الصلة الصغرى فيكون في الهاء التي تدُل على ضمير غائب في حالة كسرها أو ضمها، وأن تتوسط حرفين مُتحركين، فيكون حُكمها الإشباع، مثل: “إنه كان”.
5- مدّ الفرق
يكون مدّ الفرق في حالة سُبقت همزة الوصل بهمزة الاستفهام، فيتم إبدال الهمزة الثانية منهما بحرف مدّ، وله حُكمان: إمّا الإشباع أي النُطق بست حركات، أو التسهيل أي نُطقها بين حرف المدّ والهمزة، وتكون في ثلاثة مواضع فقط في القُرآن الكريم، “آلذكرين، ءآلآن، قُل آلله أذن لكُم”.
إن أحكام المدّ وردت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قراءته للقُرآن، لذا علينا أن نحرص على الإتيان بها حتى نقرأ القُرآن كما كان ينطقه رسول الله.